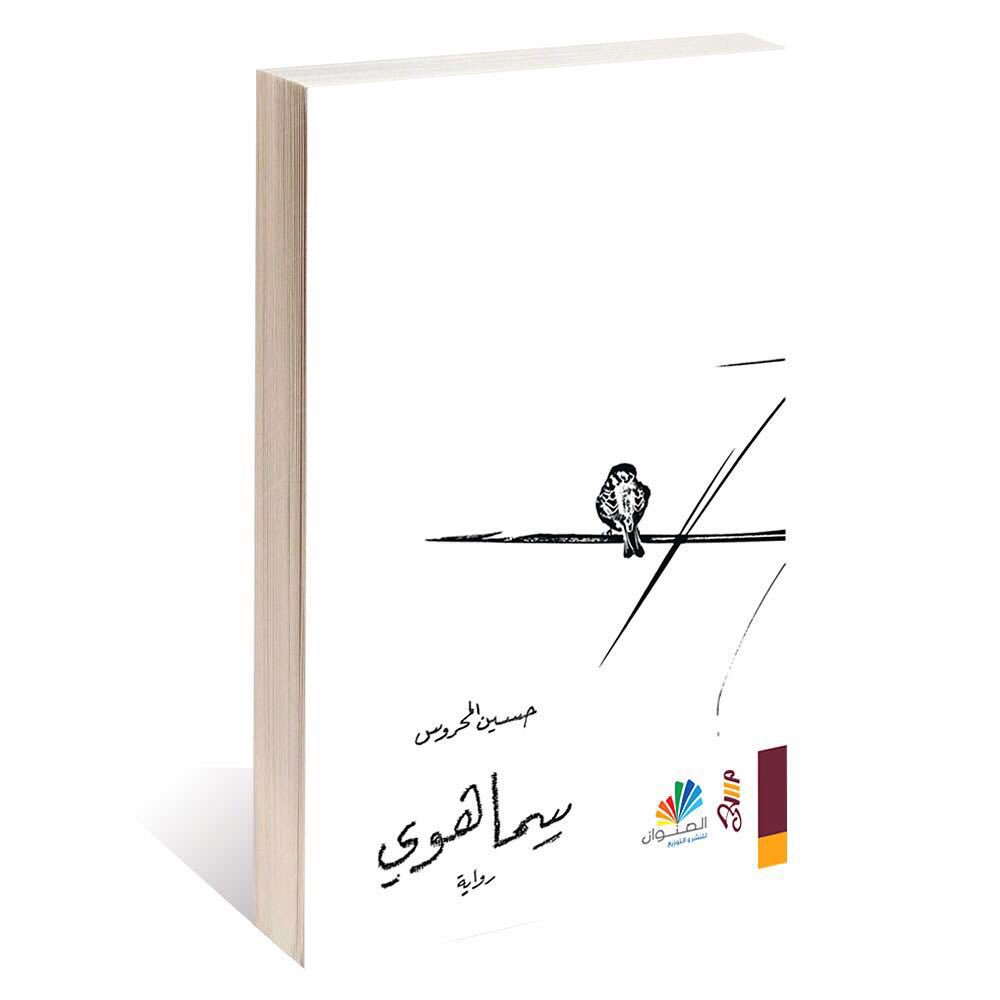لا نعرف حكاية الساعات الأخيرة من حكاية عباس السميع ورفيقيه سامي مشيمع وعلي السنكيس، ف”المحكوم بالإعدام لا حكاية له” كما يخبرنا الأديب الروسي دوستويفسكي (1821- 1881) الذي حُكم عليه بالإعدام بسبب أفكاره السياسية، لكن في اللحظات الأخيرة من تنفيذ الحكم، تم تحويلها إلى عقوبة أخف، فعاد ليحكي لنا حكاية المحكوم بالإعدام في روايته (الأبله) يقول “أما في حالة الإعدام فهم يحرمونك تماما من تلك البقية الباقية من الأمل التي تخفف وقع الموت على نفسك عشرات المرات فاليقين عن أنك لن تفلت من حكم الإعدام هو ذاته العذاب الذي ليس بعده عذاب”.
لم يتوفر الملك الذي صادق على قرار إعدام عباس وسامي وعلي، على مناقبية، لتحيي فيهم شيئا من أمل العفو أو التخفيف أو الإيقاف، كان أدنى من ذلك، وكانوا أعلى فصعدوا بحكايتهم.
(حكاية الإعدام) تلك هي المهمة التي يريدنا عباس ورفيقاه أن ننجزها، أن نحكي القصة، أن نروي ما كان يعتمل في أرواحهم ومخيلتهم، أن نُنُزل إلى الأرض القصة التي صعدوا بها إلى السماء، أن نتخيل كيف أخذوهم؟ وكيف أوقفوهم؟ وكيف وجهوا أسلحة الموت إلى وجوههم؟ وماذا أذاقوهم من ذل الانتقام؟ وكيف تلقت قلوبهم الرهيفة رصاصات الحقد؟ كيف نطقوا آخر كلماتهم؟ كيف وجهوا نظرهم إلى القاضي الذي حضر قتلهم؟ كيف أدار رجل الدين خجله وهو يعظهم؟ وكيف حضرت صور أمهاتهم في مخيلتهم الأخيرة؟ وهل كانوا مطمئنين إلى أننا مؤتمنون على رسالة دمهم؟
لقد تركوا لنا من سيرهم وقصصهم ورسائلهم ما يساعدنا لبناء الحكاية التي لم تصلنا، لنكمل فراغات حكايتهم الأسطورية، هكذا يُلهم البطل حكاية إعدامه، وكأنه يُنزلها من السماء في قلوب من يؤمنون برسالته. وتلك إحدى مفارقات الشهيد، هو قادر أن يُوحي بحكايته حتى لو لم تُتح له فرصة السرد، ذلك لأنه يُوهب حياة ولا يُعدم حياة حتى لو قضى بالإعدام.
لقد منحتهم هذه الشهادة حياة أخرى وحكاية استثنائية، ولكأن (الإعدام) السياسي في سياق الحراك البحريني كرامة تُدخر لحظتها لأصحاب قادرين على أن يجعلوا منها تاريخا وطنيا لا يُنسى، لقد تأخرت هذه اللحظة عشرين عاما، وعلى الرغم من قسوة الأحداث منذ 14 فبراير2011، فإنها لم تأت، وبقيت مدخرة ومضنوناً بها، حتى نزلت وكأنها هبة ربانية على ثلاثة شبان، صنعوا من خلالها أسطورة ينقصها شيء من الواقع لا شيء من الخيال، لكأنها طقس فداء، والمفدى وطن.
لسان حال كل شهيد للقناص الذي كان يطلق باسم الملك:”سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها”(محمود درويش). لقد صاروا فكرة وحكاية وأمثولة، بقوة قضيتهم وبخطابات أمهاتهم التي أجادت تمثيل شهادة الأبناء والنطق باسم هذه الشهادة بقوة خارقة.
لقد غدوا حكاية لا يمكن لكل أجهزة إعلام السلطة أن تزوّرها، بكل هذه الحشود الشعبية التي اصطفت في طوابير لا نهاية لها وهي تقدم العزاء لأهالي الشهداء، لقد فهموا الفكرة، وعرفوا أنهم يقفون ليثبّتوا الحكاية في التاريخ، إنهم بوقوفهم يثبتون ما تريد السلطة أن تدمره، ويكسرون ما تريد السلطة أن تفرضه.
لقد فعلوها، جعلوا الحكاية كلها هم، أولئك المحكومون بالحياة الأبدية.